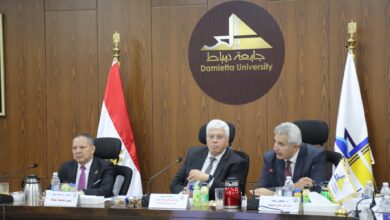عبد الحليم قنديل يكتب: مصائر السودان

يضع عبد الحليم قنديل، ما يمكن أن نسميه “الحالة السودانية” على طاولة التشريح، ويخضعها لمشرط جراح ماهر، يحاول أن يكتشف منبع الداء، الذى خلق هذه التشابكات السودانية الداخلية، والحساسية الزائدة فى علاقة أشقاء الجنوب من أبناء وادى بمصر، وخاصة على مدار التاريخ المنظور.
ويخرج الكاتب الكبير من عملية الفحص، بهذا المقال الرائع المنشور، تحت عنوان: “مصائر السودان”، ونقدمه نصه فى التالى:
كان الأستاذ هيكل يتجنب الكتابة عن السودان فى أغلب الأحوال، وقد سألوه مرة عن السبب، وكان جوابه الحذر ملفتا بمعانيه، التى تصف الوضع السودانى بأنه غابة من التشابكات والخيوط المتداخلة، ومن دون أن يغفل عن حساسية الإخوة السودانيين المفرطة، وبالذات إن كان الكاتب مصريا .
وقد بدت هذه الحساسية مفهومة، وإن كان مشكوكا فى صفاء نوايا ووعى دعاتها المثيرين للريب، فقد جمع مصر والسودان تاريخ معقد، دفع قطاعات سودانية إلى ترديد نغمة مرذولة عما تسميه “الاستعمار المصرى”، فى إشارة إلى وقائع جرت منذ قرنين وأكثر، حين اتجهت ملكية محمد على وخلفاؤه فى مصر إلى التمدد جنوبا، وبدوافع بينها استكشاف والحفاظ على أمن منابع ومجرى النيل، ورسم خرائط السودان بحدوده الأحدث.
ولم تدم روح التوسع المصرى أغلب الأوقات الملكية، فقد وقع السودان كما مصر فريسة للاحتلال البريطانى، وابتدعت إدارة الاحتلال ما أسمته “الحكم الثنائى المصرى البريطانى” للسودان، الذى كان موضع هيمنة مطلقة للبريطانيين.
ومن دون أن يكون للطرف المصرى دور يعتد به ، فقد كان حاكم السودان تحت الاحتلال بريطانيا دائما، ولم تقم فى مصر والسودان حكومة واحدة أبدا تحت الاحتلال، وإلى أن تحولت السيرة إلى مقام هزلى تماما، كان “فاروق” آخر ملوك العائلة العلوية، يحمل فيه صفة “ملك مصر والسودان”، بينما لم تكن لفاروق سلطة تذكر فى مصر ذاتها، وكان “المندوب السامى البريطانى” سيد القرار فى القاهرة، وإلى أن قامت “ثورة الضباط الأحرار” فى 23 يوليو 1952، وأبرمت اتفاقية جلاء الاحتلال البريطانى عام 1954، بعد احتلال دام 72 سنة، وانحاز جمال عبد الناصر لحق السودان فى تقرير مصيره، وهو ما حدث باستفتاء شعبى سودانى أواخر عام 1955، جرى بعده إعلان استقلال السودان فى الأول من يناير 1956، وقرر عبد الناصر وقتها منح كل الأسلحة المصرية المتواجدة فى السودان كهدية لجيش الأشقاء، وصار عبد الناصر زعيما شعبيا أعظم فى مصر والسودان والأمة العربية كلها فى خمسينيات وستينيات القرن العشرين، وجرى استقباله على نحو أسطورى فى قمة “لاءات الخرطوم” عقب هزيمة 1967.
ومن وقت استقلاله ، وتعاقب أنظمة الحكم عليه، لم ينعم السودان أبدا بصيغة حكم مستقر راسخ ، وتوالت فصول الدورة الخبيثة ، من حكم مدنى إلى حكم عسكرى يلحقه ، وتطول فتراته بالتدريج، من حكم العسكريين لست سنوات بعد انقلاب إبراهيم عبود ، ثم إلى 16 سنة زمن انقلاب جعفر النميرى ، ثم إلى حكم الثلاثين سنة مع انقلاب عمر البشير المتحالف مع جماعة الإخوان.
وبمجموع فترات حكم عسكرى، وصلت إلى 52 سنة، هى أغلب وقت السودان “المستقل” من 65 سنة مضت، بدا فيها التناقض ظاهرا، بين حيوية الشعب السودانى الفياضة فى انتفاضات وثورات 1964 و 1985 و2018 و2019.
وبين حصاد المتاهة السودانية، التى توالت فيها حروب أهلية، قتلت وشردت الملايين، وأدت لانفصال جنوب السودان عام 2011، ثم اشتعال حروب انفصال مضافة فى شرق وغرب وجنوب ما تبقى من السودان، وإلى أن جرى خلع حكم البشير، وعقد اتفاقات “جوبا” للسلام فيما بعد، التى لم تلتحق بها حتى اليوم، حركات تمرد مسلحة فى الغرب والجنوب، إضافة لتفاقم نزعات الانفصال فى “بورسودان” والشرق، ودخول أوضاع الخرطوم إلى متاهة عسكرية مدنية، لا يبدو فيها من ختام سلس لفترة حكم انتقالى كان متفقا عليها بعد نهاية ديكتاتورية البشير، وصياغة “الوثيقة الدستورية” فى أغسطس 2019، والاتفاق على سلطة مزدوجة عسكرية ـ مدنية ، جعلت قائد الجيش “عبد الفتاح البرهان” رئيسا لما أسمى “المجلس السيادى”.
وكان “د.عبد الله حمدوك” رئيسا لحكومة مدنية ، جرى تعديلها مرات ، وإشراك ممثلين لأحزاب من “قوى الحرية والتغيير” عنوان الثورة ، ودون أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية ، برغم نجاح “حمدوك” فى كسب تعاطف أمريكى وأوروبى، كان سندا لشخصه بعد إقالته بقرار “البرهان” فى 25 أكتوبر 2021 ، ثم عودة “حمدوك” باتفاق مع “البرهان” فى 21 نوفمبر اللاحق، وإخفاقه فى التفاهم مع الأطراف السياسية المتناحرة، وعجزه عن تأليف حكومة كفاءات مستقلة على مدى قارب الشهرين، ثم لجوئه أخيرا إلى استقالة نهائية، أشهر فيها يأسه من فرص نجاح حوار الأطراف المدنية ذاتها ، وإن تخلص مؤقتا من صداع اتهامه بخيانة الثورة، وعقد صفقة مع انقلاب العسكريين والجنرال “البرهان”، فى حين تواصل تدفق عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة المثلثة.
وبذات الحيوية الفياضة المشهورة عن الشبان والشابات فى السودان، وشجاعة التصدى للقمع المتعاقب، برغم سقوط مئات الشهداء والشهيدات فى رحلة الثورة الأخيرة، والتصميم على إسقاط سلطة البرهان والعسكريين، وترك الساحة كلها لحكم مدنى خالص، تبدو عناوينه مجهولة غامضة حتى للمتظاهرين والمتظاهرات.
بينما يواصل “البرهان” ومجلسه مشاوير البحث عن رئيس وزراء مدنى يخلف “حمدوك”، وسط مخاوف أغلب المرشحين من المجازفة بالموافقة، فشوارع الخرطوم لا تهدأ، وسيول الغضب الجارف لا تتوقف عن التجريف، و”قوى الحرية والتغيير” تتواصل انشقاقاتها، ومشاهد الاحتراب القبلى تخرج عن السيطرة فى “دارفور” و”غرب كردفان”، وحركات “عبد الواحد نور” و “عبد العزيز الحلو” و “جوزيف توكا” لا تزال على تمردها المسلح فى الجنوب والغرب، و”قبائل البجا” بالشرق تهدد بالانفصال وترك وحدة السودان، والأوضاع الاقتصادية تتابع تدهورها المأساوى وسقوطها الحر، والشارع الساخط لا يريد الذهاب إلى انتخابات مبكرة، تفرز حكما مدنيا كاملا، وقادة الجيش يحذرون من انزلاق إلى فوضى شاملة، وأجهزة المخابرات الدولية والإقليمية تعيث خرابا وتمويلا وفسادا فى الخلاء السودانى الموحش الخطر، وإملاءات الأمريكيين والبريطانيين وغيرهم تجرى على الهواء مباشرة.
والمحصلة بالجملة ، أن دراما السودان الراهنة تجاوزت من شهور حدود الصدام بين عسكريين ومدنيين، وجدوى المفاضلة أو المفاصلة بين حكم عسكرى وحكم مدنى، بل وصيغ حكم السودان كلها، وصار مصير السودان نفسه على المحك، وربما يكون ضغط الفترة الانتقالية التى طالت بأكثر مما ينبغى، وتراكمت خلافاتها على نحو عدمى متسلسل.
ولا تبدو لها من نهاية مأمونة ، بغير الإعداد لانتخابات عامة متعجلة، قد تسبق موعدها المقرر أواسط عام 2023، وتفرز رئيسا منتخبا وحكومة مدنية منتخبة، وهذا هو الاختيار المعلن للجيش وقائده “البرهان”، الذى تعهد باعتزال الجيش والسياسة، بعد إجراء الانتخابات وتنصيب الحكم المدنى الجديد، لكن المعضلة المرئية، أن هذه “الوصفة” التى تبدو منطقية فى ظاهرها، لا تبدو مقنعة ولا مقبولة من جماعات الشارع الغاضب، خصوصا فى “تجمع المهنيين” و “لجان المقاومة”، وأطراف جناح “المجلس المركزى” للحرية والتغيير، وكلها جماعات لا ينكر أثرها ودورها فى تحريك الشارع المتظاهر.
لكن أوزانها السياسية الانتخابية غاية فى الضعف، ربما باستثناء أحزاب تقليدية قديمة كالحزب “الاتحادى” و “حزب الأمة” وتفرعاتهما، قد تجد موطأ قدم فى انتخابات قريبة تجرى، وتخشى عودة سيطرة “الكيزان” من جماعة الإخوان وأخواتها، ومن تنامى نفوذ جماعات وأحزاب مستجدة قريبة عموما من “البرهان” ودوائر الجيش والقوى الأمنية، إضافة لأدوار انتخابية منظورة لحركات اتفاق سلام “جوبا” وغيرها فى دارفور والجنوب والشرق.
وكلها مخاوف تبدو مفهومة ، لكن التوقف عندها، لا يعنى سوى الشلل الكامل فى ماكينة الحكم بالسودان، وترك الفراغ السياسى ليحتله الجيش، وهو القوة الوحيدة الأكثر تماسكا فى السودان اليوم، فقد أدى الشجار السياسى الحزبى الذى لا يتوقف، وتوالى موجات التظاهر، وما يصحبها من عنف ودماء ووقف حال، إلى ضيق محتبس فى صدور أغلبية السودانيين الصامتة، التى تعانى بؤس “المعايش” وإغلاق الاقتصاد والغلاء وانسداد سبل الرز ، والنفور من سيرة السياسة ودعاوى الأحزاب جميعا.
وتراكم شعور متزايد، قد يسأم فكرة الثورة نفسها، بالذات مع تحول قطاع من الثوريين إلى سلوك فوضوى، يتحدث عن “مدنية كاملة”، بدون مقدرة على تشخيصها، أو تقديم قيادات جاذبة جالبة لقناعة الرأى العام السودانى، وهو ما قد يعيد “الدورة الخبيثة” لدولاب العمل، ويفتح الطرق سالكا لانقلاب عسكرى كامل، لا يبدو من بديل جاهز لتجنبه، فى بلد عظيم الموارد الطبيعية والبشرية، لكنه يفتقر إلى جهاز دولة كفء قادر، ومؤهل لتحمل صدمات وتقلبات السياسة، وإدارة حياة طبيعية مع كل هذا الاضطراب.
وقد بدا ذلك قدرا مفروضا للسودان منذ استقلاله، نأمل أن ينفك عنه ، وأن تكون مصائر السودان بقدر أحلام وأشواق بنيه الأكثر بسالة عربيا، وإن لم يكونوا الأفضل حظا .
Kandel2002@hotmail.com