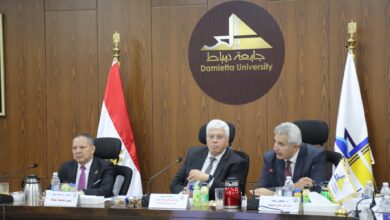عاطف عبدالغنى يكتب: عمرو موسى.. بقضه وقضيضه

رأيت عمرو موسى بأم عينى، وسمعته بأذني، منذ ما يزيد على 20 عاما، وكان ما يزال يشغل منصب وزير خارجية مصر، (تولى المنصب 1991-2001)، وفى ندوة بمعرض الكتاب، يخطب بصوت حاد فى عبارات قاطعة مانعة، وعلى الملأ معلنا: “نحن نعيش الآن عصر تصفية القضية الفلسطينية” وضجت القاعة بالتصفيق الحاد على اعتبار أن ما ذكره موسى “رأى شجاع”.
وفى صخب تهليل وتصفيق جمهور الندوة، أعاد موسى ما قاله، يؤكده، وهنا برز من بين صفوف الحاضرين فجأة المغنى العشوائى “حسن فهمى” الذى كان فى هذا الوقت يطارد كاميرات “التلفزيون” أينما تذهب ليظهر فى لقطة على الشاشة، فى كل المناسبات حتى فى صلاة الجمعة، ومباريات الكرة,
وأخرج المغنى الأجش ميكروفونا محمولا وردد بصوت نكير: “أنا بكره إسرائيل وبحب عمرو موسى “، ورددت القاعة خلفه تحيى البطل الشعبوى الذى تتماهى آرائه فى أغنية تعبر عن الكره للعدو التاريخى فى الذاكرة الجمعية، دون أن تنتبه أن بطلها هو نفسه وزير الخارجية (خارجية مصر) وأنه ينفض يديه عن القضية الفلسطينية، وكأنه ليس واحدا من صانعى القرار المصرى باعتباره الوظيفى فى هذا الوقت.
ويردد عمرو موسى فى أحاديثه الإعلامية وفى كتابه الذى يروى فيه سيرته الذاتية أن الخارجية المصرية فى عهده كانت مستقلة بقرارها فى مسائل الدبلوماسية الخارجية ما عدا القضية الفلسطينية، ولنصدقه فى هذه، لكن إذا كان الأمر كذلك حقيقة، فأن موسى ومن معه عاشوا فى مناصبهم، وعلى كراسيهم، خلال فترة التجهيز لإطلاق ما سمى فيما بعد بـ “الربيع العربى” وخلال فترة مسئوليتهم تلك بلعوا الطعم، ووقعوا فى كل الأفخاخ التى نصبتها لهم أجهزة المخابرات، والخارجية الأمريكية، والمؤسسات الغربية، والإسرائيلية الضليعة والمعنية، و “الثنك تانك” التى خططت لهذا الربيع العربى.
وقد بدأ تجهيز المنطقة بحرب تحرير الكويت (حرب الخليج الأولى 1990) وبعدها جر الغرب العرب فى مفاوضات سرية، وذلك فى أعقاب مؤتمر مدريد للسلام، وكان هدفها الأساسى التجسس على أحوالهم والسعى للتطبيع، وتجهيز التربة لتفكيك الجزء العربى من الشرق الأوسط، لتقوده إسرائيل بعد ذلك، وحدث هذا وعمرو موسى وزير الخارجية.
وما كانت إخفاقات عمرو موسى، ورجال السياسة والنخب من النظام والذين التفوا حول الرئيس فى الفترة من 1990 وحتى 2011 ، إلا نتيجة فشلهم فى تقدير المواقف، وفهم ما يحدث حولهم، من اختراق للدولة، ودفع الناس للغضب، وتثوير الشباب، وإحداث الجروح، وزياده القطيعة بين الشعب وحكامه، ولا يعرف كثير من العامة التفاصيل الدقيقة المتعلقة بهذه المخططات، لكن البعض عرف أن عمرو موسى أثناء زيارة لإسرائيل رفض أن يضع على رأسه “الكيباه” وهى الطاقية الدينية اليهودية ويزور متحف “ياد فاشيم” الذى يؤرخ لـ “الهولوكست” المزعوم.
وذكرنى بكل ما سبق رأى لعمرو موسى جاء فى ملف حمل عدد من آراء النخب العربية، السياسية، والاقتصادية، والدبلوماسية، والعلمية، تحت عنوان: «العالم في 2022… تحديات وتحولات»، نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية.
وأدلى عمرو موسى بدلوه فى الموضوع وطرح رؤيته للعالم العربى فى عامه الجديد 2022، ونشرت الصجيفة كلامه تحت عنوان: “القضّ والقضيض والعام الجديد!”
ومختصر ما قاله عمرو موسى كما جاء فى “الشرق الأوسط” إنه لن يكون هناك جديدا، وإن شئت بعبارة أكثر تفصيلا، والتعبير من عندى أن ماضى العرب وحاضرهم، ومستقبلهم، كله سواد فى سواد.
ودعنى أنقل لك بعضا مما قاله بالنص:
” إن منطق الأمور لدينا والثقل السلبي لما نتحمله في نواحي حياتنا كافة يجعل من غير المنطقي أن نتوقع خيراً كثيراً”.
“إن القوى الخارجية التي تتلاعب بأقدار المنطقة، ومنها القوى الإقليمية (غير العربية) الصاعدة، لا ترى في العالم العربي شريكاً في قيادة المنطقة، وإنما ساحة للتنافس وتحقيق المصالح التي تأتي في معظمها على حساب أهل هذه الساحة، والغريب، بل الخطير، أن الكثيرين من «أهل الساحة» لا يزالون ينتظرون خيراً من هؤلاء وأولئك”.
وأضاف سوادا فوق السواد فقال: “علينا أيضاً أن نلاحظ أمرين سلبيين آخرين، أولهما يتعلق بأن مبادرات إعادة البناء أو محاولاته تتم في أغلبها بنبرة وإدارة محلية (وطنية) دون الالتفات كثيراً إلى أهمية التكامل العربي أو (الإقليمي) الذي يمكن أن يدعم عملية التنمية الوطنية، وثانيهما أنه بالنسبة إلى التحديات الجديدة التي سوف تشغلنا في السنوات والعقود التالية، مثل الأوبئة وتغيرات المناخ، لم نرَ – نحن المواطنين العرب – أي عمل كفء في مضمونه وتنسيقه بين الدول والمؤسسات العربية المعنية.
وقبل أن ينتهى تفضل موسى بملاحظة إيجابية، لم تأت من عنده ولكن ذكّره بها أحد المسؤولين الليبيين (حسب قوله) وقال له الأخير إنهم فى ليبيا، شعروا بجوٍّ إيجابي تسلل إلى أجوائهم السياسية بعد المصالحة العربية إثر اجتماع العُلا والتهدئة الجارية بين تركيا ومصر.
وانتهى موسى إلى القول: “هناك بعض الإيجابيات الأخرى لا شك، ولكنها لا تكفي كي تشكل Trend، كما يقولون… وكل عام وأنتم بخير”. (انتهى الاقتباس).
هذا موسى الذى لايرى أملا، ولا “ترند” فى 2022 وقد استخدم لفظ “ترند” من الإعلام الرقمى، ورواد “السوشيال”، فى رأيىّ ليثبت للقارىء أنه متابع لمستحدثات اللغة الرقمية.
وبغض النظر عن الماضى وما حدث فيه، ومسئوليته عن هذا الذى حدث، ويدفع العالم العربى ثمنه “من قضه وقضيضه”، فأولى بموسى، أو قل تمنيت عليه أن يمعن النظر فى تجربة أعتقد أنه يعيش فى قلبها الآن، وهى التجربة المصرية، التى فرضت نفسها، وأفشلت مخططات وخطط كثيرة كانت تستهدف المنطقة، ومنحتنا على الأقل نحن المصريين، أملا كبيرا فى المقاومة، والتقدم للأمام، وليس العودة للخلف إلا للدرس، وحتى لا نقع فى “الأفخاخ، ونبلع الطعم”.
وأرى أنا كاتب هذه السطور أن تجربة مصر فى كل مستوياتها، والملفات التى عملت عليها، وأنجزت، يمكن أن تكون مرتكزا حقيقيا للتغيير فى المنطقة، أو على الأقل ملهما لمن يبحث عن التغيير بإرادة.
لكنه دأب عمرو موسى الهارب من المسئولية، الميال للنهايات الحادة، والآراء التى قد تبدو فى ظاهرها بطولية لكنها فى حقيقتها غير ذلك تماما، يدرك نقطة ضعفنا التى نصنع منها أساطيرنا البطولية، وهى أننا عاطفيون، نعشق زعامات الخطب، و “طق الحنك”،(باللبنانى)، والحنجورى (بالمصرى)، والأشاوش، الذين حاربوا العلوج (بالعراقى)، ويطربنا شعبان عبد الرحيم الذى غنى أنا بكره إسرائيل، ورقص عليها عادل إمام وهو “يحشش” فى العوامة مع أصدقائه، فى فيلم “السفارة فى العمارة” وردد، ورددوا خلفه “أيهههههههههههههه”.