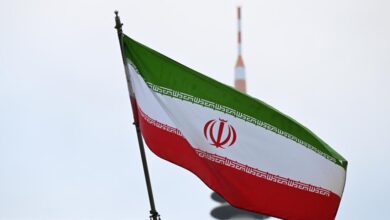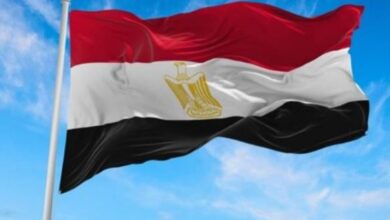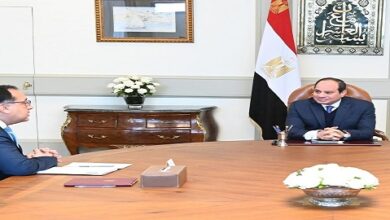محمد قدرى حلاوة يكتب: لا تصالح (1) مجنون الورد

بيان
(١)
“بنتولد…
طاهرين…
بنتولد…
شبعانين…
بنتولد…
متلهفين…
على صدر أم…
وكتف أب…
مرتاحين.”
عادة صباحية صارت لا تنقطع، منذ ظهر هذا المطرب “الأسمر” الجميل، وقد أصبح صوته إعلانًا ببداية الصباح الجديد. كان شريط “الكاسيت” قد أصابه بعض التلف (سف)… بعد عملية إصلاح ولصق مجهدة، الآن يعمل من جديد. لا شك أن هناك قليلًا من العطب… مقطع محذوف… توفير “تحويش” جنيهين ونصف كفيلة بشراء نسخة جديدة.
ما زال الكبار يستهلّون الصباح ببرامج “الراديو”: “كلمتين وبس” في الثامنة إلا خمس دقائق، بعده بقليل “همسة عتاب”. نحن جيل “الكاسيت” – وإن لم يكن “الراديو” قد فقد قيمته تمامًا بعد -. على أية حال، فقد كبرنا على برنامج “أبلة فضيلة”. لم تعد “غنوة وحدوتة” مناسبة لفَتًى على أعتاب الصبا. ألا يلاحظ أحد ذلك “الزغب” البادي فوق الشفة العليا؟ – لم يعلموا بالطبع تكرار الوقوف أمام المرآة ومحاولة حلاقة الشارب واللحية بشفرة الوالد “الناسيت” الحادة وما خلّفته من جروح -… الصوت الذي صار أجشَّ فجأة… القامة التي طالت، والجسد الذي نما… تلميذ في الصف الثاني الإعدادي صار يخجل من حمل “كيس” السندوتشات، وربما كانت أرغفة الخبز “الفينو” المحشوة “بالمِشّ” من يد “الحاج عرفة” أكثر شهية وأعظم مذاقًا.
كان “عم عرفة” يكيل بمغرفة معدنية “كبشة” من “اللوبيا” لأحد الزبائن، معبئًا إياها في “قرطاس” من الورق المقوّى. هو رجل طيب قنوع للغاية… رغيفان من الخبز “الفينو” معجونان بالمِشّ المخلوط بحواف الجبن “الرومي” القديم بستة “قروش” فقط (بقي رغيف “الفينو” الكبير بقرش واحد، ولا سيما بعد انتفاضة ١٨ و١٩ يناير/كانون الثاني عام ١٩٧٧، التي نشبت ضد رفع أسعار بعض السلع الغذائية، ومنها الخبز)… جلس بعدها على مقعد خشبي من الخوص، وقد أخرج “حقًّا” معدنيًّا من جيبه، متناولًا منه بعض “النشوق”… وبعد أن دَسَّه في أنفه، ذهب في نوبة من “العطس” الشديد… وكان “منديله” القماشي حاضرًا لاستقبال الرذاذ المنبعث.
السادس والعشرون من فبراير/شباط ١٩٨٠… طقس شتوي بارد كالمعتاد… اليوم مباراة “الدوري” الساخنة بين فصلي ثانية أول وثانية ثالث. أيام المباريات لها طقوس خاصة: تحضير زي اللعب، ومراجعته جيدًا في اليوم السابق… تخطيط الملعب بخطوط “الجير” الأبيض… عقد “شِباك” المرمى والتأكّد من إحكامها… بقيت خمس دقائق وتبدأ “الفسحة”… بعد لحظات سنكون محط أنظار التلاميذ والتلميذات جميعًا… نحلم حينها بالهدف الذي سيفوق كل أهداف “كيمبس” و”كرويف”… الكرة التي ستُنقذها من على خط المرمى والتي يعجز عن إخراجها “كرول” و”بكنباور”… تُرى، هل تراقبك بعينيها الجميلتين الآن؟ أم هي في شغل شاغل عنك؟… لا تأتي الرياح أبدًا بما تشتهي السفن… بل أحيانًا ما تغرق السفن… هزيمة مذلّة… أربعة أهداف للا شيء… اتفقنا على أن نقدّم احتجاجًا للأستاذ “عصام”، مدرس التربية الرياضية، على التحكيم الظالم… ضربة جزاء واضحة لم تُحتسب… وقت ضائع أقل من حقيقته… سيذهب “علي” بالاحتجاج ليقدّمه، وخصوصًا و”ركبته” ما زالت تنزف دمًا من العرقلة الواضحة… أمطار تهطل الآن، لعلها تمحو آثار الحزن والشجن…
(2)
يومٌ حزين بكل تأكيد… هزيمة قاسية وعرجٌ خفيف أثقل الخُطى… مضى مترو “مصر الجديدة” يهتزّ ويتمايل حتى محطة “رابعة العدوية”… ما زال متبقيًا خمسة “قروش” من المصروف… يمكنني التوقف عند “كشك” “عم حامد” وتناول زجاجة من “السفن آب”…
“أنت مالك جاي بتعرج ليه؟ شفت اللي حصل؟ الواد محمود أبو دقن اتقبض عليه في المظاهرة النهارده… الواد ده مش ناوي يحرَّم…” قال “عم حامد”.
أبديتُ بعض الاستنكار وأنا أتناول آخر رشفة من الزجاجة:
“مظاهرة إيه دي النهاردة؟ إيه المناسبة؟ هو النهاردة كام؟”
قال “عم حامد”:
“النهاردة إيه؟ ستة وعشرين فبراير… بيفتحوا السفارة الإسرائيلية في القاهرة. يوم أسود على دماغك ودماغنا كلنا… جيل مِنيّل بنيلة… جَتْكوا القرف.”
طرأ على ذهني أن أسأله: وماذا فعل جيلكم؟ وما الذي ندين لكم به من مفاخر وأمجاد؟… لكنني تراجعت سريعًا عندما وجدت عروق رقبته قد نفرت، ويده قد أشاحت، والرذاذ قد أخذ يتطاير من فمه… وكانت تلك علامات انفعال “عم حامد”… وبداية انطلاق الألفاظ البذيئة التي كنا نستقبلها مهرولين، ونحن ننفجر من الضحك.
سفارة “إسرائيلية”؟ في القاهرة؟ علم سداسي النجمة يرفرف في سمائها؟ بالتأكيد كانت أشياء تبدو فوق الخيال والتصور… لكنها في ذلك اليوم بدت حقيقة وواقعًا مؤلمًا صارخًا. كنت حينها لم أكمل عامي الثالث عشر بعد، لكنني كنت أرى اليد السوداء – يد إسرائيل – حولي في كل مكان: جيراني المهجّرين من “السويس” و”بورسعيد” و”الإسماعيلية”… أبي، الذي ظل طريح الفراش نحو ثلاثة أعوام جراء إصابته بشظية في حرب “الاستنزاف”… صوت صفارات الغارات ونحن نهرع نحو المخابئ ما زال يدقّ في أذني… “الجلاد” الأزرق على الزجاج يمنع ضوء الشمس، كيف أنساه؟ كيف لي أن أمحو النقوش المحفورة في أخاديد العقل الصغير بعد؟…
كانت معضلة حقيقية وأسئلة حائرة بلا إجابة… ولربما لم أنجُ من الحيرة والتخبط حتى اليوم.
(3)
في هذا اليوم المشؤوم، كان الرئيس “السادات” في المقر الرئاسي بقصر “عابدين” يتسلّم أوراق اعتماد ثلاثة سفراء. تقدَّم نحوه أحدهم بلحيته المرسومة بدقة والمختلطة ببعض البياض، وجلس معه على الأريكة يلتقطان بعض الصور ويبتسمان “للكاميرا”. “إلياهو بن أليسار” (٤)، أول سفير “لإسرائيل” في “القاهرة”.
بدا أمرًا غريبًا أن تستقبل دولة سفيرًا لدولة أخرى ما زالت تحتل أرضها، وتقيم معها أيضًا علاقات دبلوماسية، لكن “التطبيع” كان مطلبًا “إسرائيليًا” مُلحًّا، واستجاب له الرئيس “السادات”.
أمام الصحافيين المحتشدين، قال “السادات” مخاطبًا السفير “الإسرائيلي”:
“أنت الرجل المناسب.. في الوقت المناسب.. وفي المكان المناسب”.
وردّ “إلياهو” المجاملة الدبلوماسية قائلًا:
“إنني أعيش أعظم لحظة تاريخية في حياتي”.
واختتم الرئيس “السادات” مراسم الاعتماد مضيفًا:
“إنه رمز حيّ على تصميمنا الجادّ الحازم في العيش بسلام ووئام.. ليُضيء كلٌّ منّا شمعة تفاهم وتعاون”.
بالتأكيد كانت عبارات مجاملة بحتة تُخفي الواقع والحقيقة، فقد كانت أصوات المظاهرات في أماكن متفرقة من القاهرة – وإن كانت بأعداد محدودة -، ونحيب النساء وصراخهن وهنّ يرين العلم “الإسرائيلي” يُرفع فوق إحدى البنايات بحي “الدقي”، أعطت تلك المظاهر مؤشرًا واضحًا على شكل “التطبيع” الشعبي القادم، وكان سرابًا لم يروِ الظمأ أبدًا.
على الجانب الآخر، كان “سعد مرتضى”، أول سفير “مصري” في “إسرائيل”، يقدّم أوراق اعتماده للرئيس “الإسرائيلي” إسحاق نافون، وألقى “مرتضى” كلمةً مشددًا فيها على الالتزام “المصري” بتنفيذ اتفاقيات السلام المبرمة، ومذكّرًا “بالروابط القديمة التي تضرب بجذورها عميقًا في تاريخ الشعبين المصري والإسرائيلي منذ آلاف السنين (كذا!!)”.
ورد “نافون” بلهجة “تبشيرية”، داعيًا “جميع الدول المحبة للسلام في العالم أن تساند جهودنا – مصر وإسرائيل – لإرساء قواعد السلام مساندة فعلية، ولا تقوم بأعمال من شأنها إجهاض الشتلة الغضّة التي غرسناها في هذه الأرض المشبعة بالدم”.
كان “مناحم بيغن”، رئيس الوزراء “الإسرائيلي”، يبدو عليه السعادة بتلك المناسبة، وهو يصرّح قائلًا:
“إن تبادل السفراء نقطة تحول.. وهو يوم تاريخي من دون أدنى شك”.
واختتم حديثه لراديو “إسرائيل” بالقول:
“هذا يوم رائع وجميل ومهم لكلا البلدين”.
وهاتف “السادات” مهنئًا إياه بمناسبة تبادل السفراء.
ولم تنسَ وكالة “اليونايتد برس” أن تشير إلى أن حرس الشرف الذي كان في استقبال السفير “الإسرائيلي” كان يرتدي بزّات على غرار الحرس النازي الألماني (!!).
على أية حال، كانت تطلعات وأمنيات “السياسيين” تسير في مدارات محلّقة، بعيدًا تمامًا عن مشاعر ومسارات الشعوب. وكانت الأيام القادمة خير دليل وبرهان. بل إن اليوم – “الاحتفالي” – ذاته لم يكن مُقدَّرًا له أن يمرّ هكذا ناعمًا بأحلام وأوهام السلام القادم.
فقد كانت هناك صرخة تنطلق من أعماق الريف المصري، تجهر بالرفض وتصرخ بالممانعة، معكّرة أجواء الاحتفال، ملبدة سماءه. في ليلة شتاء قاسية، كان صوت “مجنون الورد” يدوي مفسدًا عزف الجوقة المنشِدة، مبددًا رونق الحدث والمباركات الحارة.
……………………………………………………………………………………………………………………
(الهوامش):
(١) “ماريو كيمبس” نجم منتخب “الأرجنتين” وهداف كأس العالم 1978، “يوهان كرويف” نجم المنتخب “الهولندي” وأحد أعظم لاعبي العالم، “رود كرول” المدافع الصلب للمنتخب “الهولندي”، “فرانز بيكنباور” القيصر، أعظم لاعب في تاريخ “ألمانيا الغربية” والتي كانت مقسمة شطرين حينها – شرقية وغربية.
(٢) “عم محمود أبو دقن”، شاب في مقتبل العمر يكبرنا بنحو خمسة عشر عامًا. يمكنك أن تميّزه ببضعة أشياء: لحيته بالطبع، ابتسامته الدائمة وحنوّه على الصغار، “سيجارته” المتدلية من جانب شفتيه في كل وقت وحين، الثقوب الصغيرة المحترقة على ملابسه، بدنه النحيل وقامته المنحنية، دائم النظر نحو الأرض كمن فقد شيئًا يبحث عنه ويفتش. تقلب “عم محمود” بين التيارات والاتجاهات السياسية تمامًا كتقلّب عصره وحيرته، من اليسار إلى التيارات “الإسلامية”.
“خدوا بالكم ده شيوعي.. خدوا بالكم ده جماعات”، دائمًا الجميع يحذرنا من التقرب منه، لكننا ما نكاد نراه حتى نلتف حوله. يحدّثنا ونسأله، لا يبخل بجواب مبسّطًا إياه وقد أحاطه بالدلائل والأحداث والبراهين، ما يجعله – الجواب – ثابتًا راسخًا لا نقبل له تأويلًا من بعده. وها هو يُقبَض عليه ثانية، بعد سابقة القبض عليه في أحداث “انتفاضة الخبز” “يناير / كانون الثاني” عام 1977.
(٣) كان حينها أغلب سكان حي “رابعة العدوية” وأحياء أخرى كاملة من “مدينة نصر” من أهالي محافظات “السويس” و”الإسماعيلية” و”بورسعيد”، المهجّرين جرّاء عدوان “يونيو / حزيران” عام 1967.
(٤) لم يستمر “إلياهو بن أليسار” في منصبه أكثر من أحد عشر شهرًا، وطلب بعدها إعفاءه من منصبه بعد التجاهل التام الذي لاقاه على المستوى الشعبي. وذكر في مذكراته أنه لم يكتسب صداقات أحد أثناء عمله بـ”مصر” سوى ثلاثة، أحدهم سائق سيارته.
اقرأ أيضا للكاتب: