بين مصر واليمن.. علي أحمد باكثير والمشترك الثقافي (1من3)
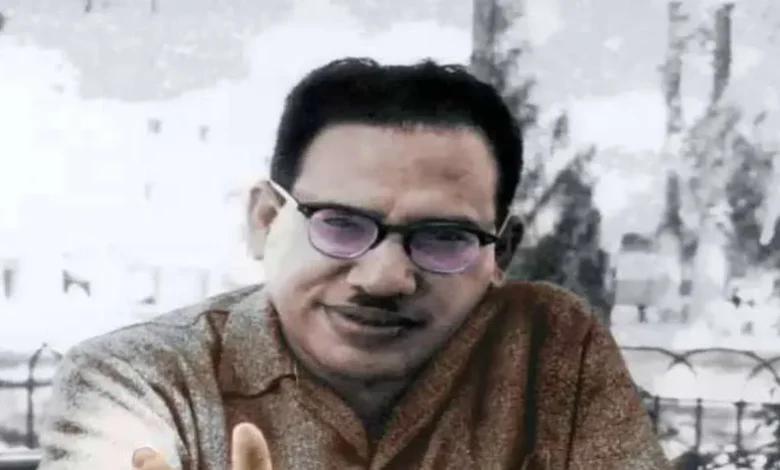

دراسة يكتبها: د. قاسم المحبشى
ونحن نبحث في أوجه الروابط الثقافية المشتركة بين مصر واليمن ذكرني الصديق العزيز الدكتور حاتم الجوهري بشخصية الأديب الكبير علي أحمد باكثير حضرمي الأصل مصري الجنسية وما كان له من شأن ومقام في تجسيد المشترك الثقافي بين البلدين بأفق عربي لا تخطئه العين واتذكر أنني كتبت في مئوية ميلاده دراسة عن موقفه من التاريخ والسياسة اليكم نصها لعلها تحفز الباحثين لاستلهام موضوعات مشابهه للمشاركة في المؤتمر الدولي عن المشترك الثقافي بين مصر المزمع انعقاده في ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢م وهو القائل :
إذا ثقفت يوما حضرميا *** لجاءك آية في النابغين

إعادة قراءة باكثير
“كلما ابتعدنا عن لحظة رحيل الأديب المثقف العربي الكبير علي أحمد باكثير زاد إحساسنا بأهميته وقيمته الثقافية والإبداعية والنقدية، ومن ثم الحاجة إلى إعادة قراءته وتامله وفهمه من جديد.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية أخذ باكثير وأعماله يستقطب اهتمام الباحثين والنقاد من مختلف فروع المعرفة الإنسانية الأدبية والثقافية، وبات مثار نقاشات ومحاورات وكتابات وندوات ومؤتمرات متلاحقة مختلف الدوائر الإعلامية والأدبية والأكاديمية العربية والإسلامية، إذ شهدت القاهرة مؤتمر “علي أحمد باكثير ومكانته الأدبية” مطلع يونيو المنصرم.
كما كرَّست عدد من المجلات العربية الشهرية والفصلية أمثال مجلة الهلال المصرية ومجلة الرافد الإماراتية عددًا من أعدادها لعلي أحمد باكثير بمناسبة الذكرى المئوية لمولده، وأعلنت جامعة عدن التحضير لمؤتمر فكري عن باكثير، وهذا ما فعلته الأن، فما الذي يفسر انبعاث العاشق الحضرمي وتوهجه في فضاء الثقافة العربية المعاصرة؟ وما الذي جعله يحظى بهذا الزخم المثير وهذا الدفق المتواصل؟ وكيف أحرز هذا المجد المعنوي الرفيع بعد أن كاد يضيع من الإهمال والنسيان؟.
إرث أدبي ثقافي متفرد
إنَّ العمل الجليل الشأن الذي أنجزه الباحث د. محمد أبو بكر حميد المتمثِّل فى جمع وفهرسة ودراسة ونشر معظم أعمال باكثير في عدد متواصل من الإصدارات المهمة، هذا العمل ينطوي على أهمية مزدوجة، فهو من جهة قد أسدي خدمة سامية للثقافة العربية والإسلامية وللتراث الإنساني في حفظ وإشهار تحفة فنية ثقافية رائعة قلَّما يجود بمثلها الزمان كاد يطويها الإهمال والتهميش والنسيان بأسباب مقصودة وبسبب ضياع بعض نصوصها وتشتتها في قصاصات مبعثرة ومتفرقة غير مكان، كما أنه بما أنجزه من نشر أعمال باكثير ومن دراسات وأبحاث قد قدَّم فرصة نفيسة للباحثين والدارسين والنقاد العرب والمسلمين وغيرهم للوقوف عند هذا الإرث الأدبي الثقافي الذي يُعَدُّ بحق واحدًا من أعظم الأدباء العرب والمسلمين في القرن العشرين بما تفرَّد به من إنتاج غزير في الفنون الأدبية الأساسية “الشعر والرواية والمسرحية”(1)، فضلًا عن ما تكتسبه أعماله من حيوية وراهنية، إذ أنَّ كثيرًا من المشكلات والتحديات التي تصدَّى لها باكثر منتصف القرن الماضي ما زالت تهيمن على حياة جیلنا، بل غدت أكثر تعقيدًا وخطيرة لا سِيَّما في أبعادها السياسية والثقافية
والسؤال الذي يطرح نفسه ونحن نطل على بكثير من شرفات العقد الرابع لرحيله هو: كيف يمكن لنا النظر إلى ذلك الأديب المثقف؟.
موقف نقدي
نعتقد أن خير وسيلة لتكريم المبدعين لا تكمن في الاحتفاظ برماد مواقدهم، بل في إذكاء الشعلة التي أوقدوها وجعلها متقدة متوهجة على الدوام، وهذا لا يتم إلَّا باتخاذ موقف نقدي منهم ومن لغتهم ونصوصهم، ومن مجتمعهم، ومن السياق الثقافي الذي عاشوا وتألموا وفكروا وكتبوا في فضائة.
فإذا ما أردنا أن نُقدِّر القيمة الحقيقية لباكثير فلا بُدَّ لنا من النظر إليه في السياق الاجتماعي والثقافي الذي ولد ونشأ وتعلم وعمل وأزهر في أرضه وفضائه، والسياق هو كامل الوسط الذي يحيط بالنص أو الخطاب من جميع الجهات.

أهمية الموضوع:
رُبَّما تكتسب هذه الورقة أهميتها من الموضوع الإشكالي “السياسة والتاريخ عند باكثير”، إذ أنَّ ما دفعنا للكتابة ليس مجرد الرغبة في المشاركة بالاحتفاء، بل نابع من اعتقادنا بأنَّ الموضوع لم يُبحث أو يُدرَس دراسة منهجية نقدية مستقلة، إذ وجدنا أنَّ معظم الدراسات التي تناولت باكثير قد أشارت بهذا القدر أو ذاك إلى بُعْدَيّ السياسة والتاريخ في أدبه وصنفت أعماله إلى السياسية والتاريخية، لكن على كثرة استخدام وترديد ألفاظ التاريخ والسياسة والإسلام والعروبة عند معظم الدارسين، لم نعثر على إجابات شافية للأسئلة الآتية:
لماذا جاءت معظم أعمال باكثير الشعرية والسردية والدرامية مسكونة بشجن سياسي تاریخي؟ وكيف يمكن لنا فهم العلاقة التفاعلية بين أدبية باكثير والخطابات الأيديولوجية سواء السياسية منها أو غير السياسية؟.
فنحن نود هنا أن ننجز مقاربة نقدية سوسيولوجية محاولين الكشف عن التداخل والتفاعل في شخصية باكثير بين الأديب والمثقف، بين الإبداعي والأيديولوجي، بين الذات الشاعرة ورغباتها واحلامها وآمالها وأوهامها، والتحديات والضغوط الاجتماعية والتاريخية، بين الأدبي والفكري. إذ أنَّ العلاقة بين الأدب والفلسفة “الفكر ” في علاقة معقدة ومتداخلة ومتخفية ومتلبسة غير متاحة للرؤية، بل تستدعي البحث والكشف وسبر الأغوار”(2).
منهجية البحث :
شهدت الثقافة المعاصرة وما بعد الحداثة نموًا وازدهارًا لسلسلة متواصلة من المفاهيم والنظريات والمدارس والاتجاهات النقدية الأدبية والثقافية، منها النقد الفلسفي، والنقد الاجتماعي، أو علم الاجتماع الأدبي، والفلسفة الأدبية والتأويلية والسميولوجيا، وغيرها التي أصبحت تُعرَف اليوم بالدراسات الثقافية أو “النقد الثقافي”(3) الذي يمزج بين النقد الجمالي والنقد الأجتماعي، وهذا النقد الجديد ينطلق من رؤية منهجية تقوم على أساس النظر إلى النص من حيث هو جزء من خطاب، فهو نتاج مجموعة متشابكة من التفاعلات والعلاقات والقوى الاجتماعية الثقافية المتعينة زمانًا ومكانًا، وأنَّ الكاتب أو الأديب منتج النص هو كائن اجتماعي وهو مثل غيره من الناس يُمثّل ظاهرة اجتماعية، وهو أيضًا الناطق الواعي أو غير الواعي باسم المجتمع الذي ينتمي إليه، ومن الخطأ النظر إليه بمعزل عن الواقع المعاش، وكأنه نسر يرقب المشهد من فوق قمة جبل عالية، بل بوصفة جزءًا من ذلك السياق الذي عاشه، ومن ثم فهو محدد بحدود عصر، ومجتمعه، وزمنه.
وبالاتساق مع هذه الرؤية المنهجية الفلسفية السوسيولوجية الجديدة يمكن تأكيد أنَّ الأدب والفكر ممتزجان، فليس هناك خطاب أدبي صِرف، وبالمثل لا يوجد خطاب أيديولوجي أو فلسفي صِرف، ولا يوجد في الواقع إلَّا خطابات ممتزجة تتداخل فيها وفي مستويات لغوية ولهجات وأفكار مستقلة في أنظمة مراجعها و مبادئها(4)، في ضوء هذا المنهج يمكن لنا النظر إلى عمل ياكثر بوصفة خطابًا ينطوي عينيته على عدد من الأصوات والخطابات والأساليب والأفكار والمواقف التي لم تكن في حقيقة أمرها إلَّا حصيلة مباشرة لاحتدام الممارسة السياسية والاجتماعية والثقافية في اللحظة التاريخية المتعينة.







