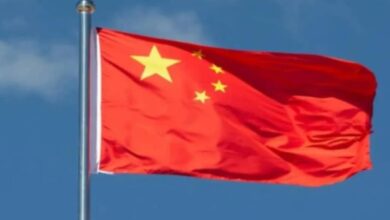محمد قدرى حلاوة يكتب: « بحري »

بيان
(١)
أكتوبر عام ١٩٧٢.. اليوم الأول في المدرسة.. ذلك العالم الغريب الحميم… حقيبة سوداء كبيرة ذات قفل نحاسي أصفر تثقل اليد.. قلم رصاص و ممحاة ومبراة.. مسطرة ملونة وبعضا من كراسات التسعة أسطر والمربعات.. ألوان الشمع و ” كيس” السندوتشات.. ثلاثة ” قروش” مصروف مندسة فى جيب البنطال أتفقدها كل حين.. صوت ورق الجرائد المنبسط على الصدر تحت الزي المدرسي لتخفيف نوبة البرد والسعال.. الحذاء اللامع الجديد.
عندما ولجت من باب المدرسة كنت متهيبا بعض الشئ.. صخب وضجيج.. أطفال كثيرون يركضون.. يتقاذفون الكرة.. بضعة معارك صغيرة تخلف وجوها محمرة مخدوشة وفوضى في الهندام.. جرس ضخم متصل بحبل طويل.. علم ” مصر” بنسره الأصفر يقف شامخا على ساري عال يرفرف مع الهواء.. أصبحت الآن جزءا من هذا العالم الذي يموج بالانفعال والحركة.. على الآن أن أتلمس وأكتشف عالمي الجديد.
كنت مفتقد ” الراديو” و ” أبلة فضيلة” تحكي ” غنوة وحدوتة” والغناء في الخلفية ” ياولاد.. ياولاد.. تعالوا معايا..”.. لا تلفاز أو أفلام كارتون عالم ” ديزني” السحري.. ألعابي الصغيرة حتى المحطم منها.. سيارة قد فقدت إحدى عجلاتها.. ” الميكانو”.. الحيوانات المجسمة.. الجنود التي تحمل البنادق يمضون وسط الدبابات وطائرة في يدي تزوم من فوقهم وصوت يصدر من فمي ” فووووو “.. كانوا يهزمون إسرائيل دائما.. القطار الذي يمضي على القضبان بسرعة حتى تنفذ ” البطاريات”.. مجلات ” ميكي” و ” سمير”.. لم تدم مشاعر الفقد كثيرا.. فقد جدت طقوس وعوامل بهجة جديدة إحتلت مواطن الشغف.. وأزاحت القديم.. وإن كانت بالطبع لم تمحه بالكلية.
طابور الصباح وتحية العلم.. نقف بانتظام متصلبي الأجساد.. ” مدرسة صفا.. إنتباه”.. ” والله زمان يا سلاحي.. أشتقت لك في كفاحي “.. الإذاعة المدرسية تذيع الأنباء ” الرئيس السادات يوجه الحكومة بالاستعداد للمعركة.. الرئيس السادات يستقبل السفير البريطاني ويحذر من حالة اللا سلم واللا حرب.. الرئيس السادات.. الرئبس السادات.. “.. منذ ذلك الحين علمت أن أخبار العالم صارت هي أخبار الرئيس.. أي رئيس.
الفناء ” الحوش” المتسع ووقت ” الفسحة”.. مباريات الكرة.. المسرح.. المكتبة.. كانت المدارس حينها عالما فسيحا مكتفيا بذاته.. لم تكن قد تحولت بعد إلى كتل خرسانية وفصول مكدسة.. حصة الألعاب.. دروس الزراعة: حبة الفول والحلبة والبصل على قطعة القطن داخل الكوب الزجاجي.. فعلتها مع أبنائي وراقبت نموها بذات اللهفة والشغف واضطررت للتخلص منها بنفس الأسف والحزن. هل كنت أمنحهم البهجة أم أستعيدها في الحقيقة؟.
الحفلات المدرسية.. والأصدقاء.. الحصاد الباقي أبدا والذي ينمو ويكبر ويتجذر كلما شاخ وكبر.. الصداقة تتحدى الزمن.. تبارز قوانينه.. تتحداه.. هل كان يبقي للحياة مذاقا بدونها؟.. وهل نحصد من هشيم الحياة سواها؟.. أي حصاد هذا الذي يزداد خضارا وينعا ولا يموت أبدا.
(٢)
كان يجلس بجواري في الصف الثاني.. ” معتز” ذلك الفتى السكندري الأشقر.. كان في ذات طولي تقريبا.. ينتشر ” النمش” البني فى وجهه مثل قطرات سقطت من ريشة فنان حاذق.. أنفه الروماني.. و حكايته عن عمته المهاجرة لأمريكا.. دعتنا إلى أن نطلق عليه ” معتز الأمريكاني”.
جاء مع والده من ” الإسكندرية” لظروف عمله بصحبة والدته وشقيقته ” ريم”.. كان يحدثنا دائما عن بيتهم في ” بحري “.. حيث الصيادين يفترشون عرض الطريق بـ “طاولات” السمك.. عن البحر و ” غية” الحمام على سطح المنزل.. ” النعناع” و أصص ” الزهور” وهو يرويها بيده.. عن عمه الذي ذهب ليسبح في البحر ولم يعد.. أخبرنا أن روحه مازالت تحوم في المنزل.. وأن هناك من أقسم أنه رآه يغدو ذاهبا لممارسة عادته الصباحية مقارعا الأمواج.. وزادني ” معتز” فى القول بأن روح عمه تحضر كثيرا فيه.. وأحيانا ما يكون مدخل المنزل مبللا بقطرات البحر وكأن عمه قد عاد من توه من رياضته الصباحية التي اعتاد عليها صيفا وشتاء.. مسكنه مازال مغلقا.. يضم حاجياته… لا يجرؤ أحد على دخوله سوي الجد.. الذي يمضي نحوه يوميا بعد صلاة العشاء حاملا البخور.. تعلو أصوات ضحك وبكاء لا ينقطعان.. ليخرج جده بعدها فرحا بشوش الوجه قائلا له: ” عمك باعت لك السلام”.
” ريم”.. تصغره بعام واحد فقط.. تختلف ملامحها تماما عن قسماته.. تبدو بشعرها الأسود الفاحم وعيونها العسلية الواسعة.. كأميرة فرت من بين دفات كتب الأساطير.. يلوح لمعان وجهها الصبوح كعروس البحر وقد خرجت منه من توها دون أن تلمح قطرات ماء متساقطة.. كنت أشعر بالضيق عندما تتحدث أو تلهو مع أحد غيري.. هل كانت تلك مشاعر الغيرة؟!.
كنت أقرأ لها قصص ” المكتبة الخضراء” ومجلة ” ميكي”.. لم تكن قد تعلمت القراءة بعد.. نضحك كثيرا حينها.. يلوح على وجهها الخوف والذعر من قصص العفاريت وجنى المصباح.. في ضحكها وخوفها وعبوسها حكاية أخرى.. لا تروى ولا تحكي.. فقط تشاهد وتعاين وتعاش.
لم نفترق ثلاثتنا.. دعاني ” معتز” فى الصيف لزيارته بالإسكندرية.. لم تسنح لي الفرصة حينها لبضعة أعوام.. إلي أن تمكنت يوما من زيارته.. هناك أياما من عمر الزمن تبدو خالدة.. كالوشم على الجلد.. كالنقش على الأعماق.. مثل قصيدتك أو قصتك الأولى.. لها سحر وذكري ومذاق.. كاللوحة المعلقة على الحائط… تشاهدها كل صباح… تلمح فيها كل حين تفصيلية جديدة.. رتوش أخرى.. قد يصبها بعض الغبار.. ما إن تنفضه حتى تلوح بهية طازجة كأن ألوانها لم تجف بعد.. تثمن قيمتها كلما مر الزمن.. أليس غريبا أن تبقى أياما بذاتها خالدة في أذهاننا وتمحي منها سنوات وعقود؟.. عجيب هو حساب الزمن.. أشياء تبقى ببكورتها لا تشيخ ولا تغيرها تجاعيد وتغصنات.. وأشياء أخرى كأنها لم تمر.. كأنها لم تكن.
(٣)
الخميس الخامس من يونيو عام ١٩٧٥.. وصلت إلى البناية السحرية أخيرا.. وجدتها تماما كما وصفها ” معتز”.. الباب الخشبي ” الأخضر” المدهون ” بالزيت”.. الطلاء الجيري الذي يحيط بالبناية.. الشرفات الخشبية الكبيرة مشرعة.. باعة السمك يجلسون ” بالطوالي” والسمك يقفز يائسا وقد بعد البين عن البحر.. وأصوات زاعقة تنادي على بضاعتها.. كانت البناية متوسطة الإرتفاع.. مكونة من دورين.. الدور الأول يسكن فيه جد ” معتز”.. والدور الثاني تقطن فيه أسرته.. أما الدور الأرضي فقد ترك خاليا… كان يقطن فيه عمه الراحل .. ورفض جده أن يشغله أحد منذ ذلك الحين.
لوح لي ” معتز” من شرفة الدور الأول.. .كنت أجتاز الدرج جريا صعودا إلى ” معتز” وخيال ظلالا تتحرك من خلف زجاج ” شراعة” باب المسكن المغلق.. ورأيت المدخل المندي بماء البحر بعيناي… هل لذلك السبب خشيت دهرا من العوم؟.
بعد ترحيب الأسرة جلست مع ” معتز” فى الصالة.. أتت ” ريم ” بجديلتها المعقودة وقد ترامت خصلات منبسطة بعناية على جبهتها زادتها حسنا على بهاء.. كنت أحمل نسختين من مجلة ” ميكي”.. تجادلنا وتبارينا في حل لغز ” المفتش عاطف”.. كان هناك جدالا آخر أكثر حدة يدور بين أسرة ” معتز”.. التلفاز يذيع حفل افتتاح ” قناة السويس” بعد تطهيرها من آثار العدوان.. بدا الرئيس” السادات” مزهوا في كامل أبهته وهو يرتدي البزة العسكرية البيضاء. وقد كلل صدره الأوسمة والنياشين.. نظارته الشمسية العريضة كانت تغطي نصف وجهه وقد أخذ يشير للحضور بعصاه المعقوفة الشهيرة.. حول المدمرة الحربية التي يعتليها الرئيس كانت تجول بضعة سفن وقوارب تحمل الأهالي المحتفلين بعودة القناة للملاحة.. أصوات الطبول والمزمار وأنغام السمسمية تطغى على المشهد.. وسط الخطب الحماسية قال والد ” معتز”: ” ضربة معلم.. اختار يوم النكسة علشان يمحي ذكراه الحزينة.. الناس فرحانة إنها رجعت بيوتها – كان أهالي السويس وبور سعيد والإسماعيلية المهجرّين قد بدأوا العودة لمدنهم قبل ذلك في عام ١٩٧٤ – أشاح الجد بيده معترضا وقد ألقى مسبحته بجواره على ” الكنبة الإستامبولي” مستندا على إحدى الوسائد ” رجوع الأهالي وعودة القناة ده دليل إنك مش هتحارب تاني.. النكسة ميمحيهاش افتتاح وزيطة وطبل وزمر.. النكسة يمحيها إنك ترجع أرضك زي ما خدوها بالضبط، بالحرب والدم”..
مضت فترة صمت تخللتها ضحكاتنا نحن الصغار.. أشار الأب بيده نحو التلفاز ” بص يا حاج إبن رضا بهلوي – شاه إيران – واقف أهوه مع جمال السادات “.. رمقه والده بنظرة غير مبالية من خلف عويناته.. واستمر في القبض على مصحفه وترتيل آيات القرآن الكريم.
صعدنا نحو السطح.. كنت أمسك بيد ” ريم” ونحن نتجاوز بعض درجات الدرج المحطمة حتى لا تتعثر.. خطفت النظر نحوها ووجدتها تبتسم في خجل.. هناك مشاعر تشعر بها مرة واحدة في العمر ولا تتكرر.. لا تفسر ولا تحتويها الكلمات.
كان البحر يبدو أمامنا بأمواجه المتلاطمة بلا نهاية.. والسماء تحتضنه والسحب ترتحل بلا مدى.. هكذا الحياة كانت تبدو أمامنا حينها مشرعة الأبواب بلا حدود ولا عثرات.. أسراب الحمام الأبيض تهبط لتضع منقارها الصغير في صحن الماء الفخاري.. ترتشف بعض القطرات لتعود فاردة أجنحتها محلقة في السماء الرحبة.. أصوات الطيور في ” العشة” وهي تتصارع ويتطاير ريشها.. نسمات هواء البحر برائحته المميزة وهي تتسلل في ثنايا الصدور مختلطة بعبق الزروع المخضرة.. ” ريم” تقف هناك في زاوية بعيدة.. تربت على يمامة صغيرة وتنظر نظرة عابرة خافضة رأسها وتبتسم.. تتطاير خصلات شعرها على الوجه متمردة كموج البحر.. الحياة كلها قد اجتمعت هنا.. في هذا الحيز والأفق.. لكن اللحظات لا تبقي على حالها، ولا تقبض عليها اليد.
هبطنا نجري نحو مدخل البناية.. ألقى ” معتز” السلام على روح عمه الحاضرة دوما وأبدا.. جلسنا على الطوار نلعب “الليدو”.. كانت بعض القطط تخطو أمامنا في كسل.. تمد جسدها كأنها تتثائب بين وقت وآخر.. الطعام وفير وبقايا السمك أكثر.. لا شئ يستحق الصراع.. أي عالم من السلام هذا؟.. البلاطات السوداء البازلتية التي تكسو الدرب تشي بعراقة وتاريخ تليد.
هبط الجد بجلبابه الأبيض الناصع محركا مسبحته ومتمتما ببعض الأوراد.. مسح على رؤوسنا وهو في طريقه لأداء صلاة العصر.. حركت قطعة أخرى من ” الماركات” حتى لا أطيح – أأكل – ” بماركة” ” ريم” وتخسر.. من الرائع أن تبقى ابتسامتها البديعة دائمة لا تفقدها .. رغم أن حزنها جليل بديع أيضا.
(٤)
عاد الجد من الصلاة.. مد يده في جيبه وأعطانا قطعا وافرة من الحلوى.. وقال لنا بلهجة ودودة لا تخلو من الحزم.. ” أوعوا تأكلوها كلها.. الغدا خلاص على النار.. متخلوش القطط تأكل أكلكم.. ومحدش يهوب ناحية البحر.. لو عزتم حاجة اندهوا عليا أنا صاحي”.
مضى، الجد نحو المدخل وقد توقف لدقائق أمام باب العم المغلق رافعا يده نحو السماء يبتهل. ثم واصل طريقه صاعدا وهو يقبض على ” الدرابزين ” بيده بقوة وقد انحني جسده ومضى يكفكف بعض قطرات الدمع الساقط والمختلط بلحيته البيضاء بيده الأخرى.
تصاعدت رائحة السمك المشوي الطازج مختلطة بعبق أرز الصيادية الشهي.. رحيق خلطة السمك المقلي ينفذ في الأنوف.. شعرنا بالجوع الشديد.. وكانت وليمة لم يغب مذاقها عني حتى الحين.
اقتربت الشمس من الرحيل.. وبدأ القمر يتأهب ليضئ ليل الحائرين.. والنحوم تهدي السائرين.. حان وقت الرحيل.. عانقت ” معتز” وسلمت على ” ريم”.. لم أكن أعلم أنه الوداع الأخير.. كان فراقا على وعد بلقاء.. بعد شهر واحد هاجرت أسرة ” معتز” إلى ” أمريكا” بدعوة من عمته.. ظل جده وجدته وحدهما هنا.. رفضا أن يغادرا.. علهم يعودوا.. عل عمه يعود.. صار ” معتز الأمريكاني” حقا.. ولكن ماذا عن” ريم”.. هل وجدت أمير الأساطير الذي خطفها على حصانه الأبيض.. انقطعت الأخبار وشحت الأنباء.. وبقي صدى ذلك اليوم معقودا في فضاء الذكري وثناياها وأطيافها.
خمسة وأربعون عاما ونيف مضت علي ذاك اليوم.. مررت اليوم على البناية العتيدة، كان السكون يخيم على جنباتها.. الدرب رصف وتلوث ” بالإسفلت” الكريه.. حتى القطط قد عادت لتتصارع وتتعارك رغم الرزق الوفير.. مالذي تغير؟. وأين ذهبت الأصوات والخطوات والضحكات والأحزان والجلبة.. كم يبدو الزمان قاسيا.. يمنحك اللحظة ولا يمكنك استعادتها.. لا يسمح لنا بأن نخلف صدى أو أثرا.. يهب ليمنع.. يعطي ليأخذ.. لا تراهن على الزمن ولا تقامر.. هل تعلم من أحد قد فاز في تلك اللعبة التعسة الخاسرة بعد؟.
كان الباب الخشبي مواربا.. مقبض الباب النحاسي سقط وبقيت آثار ظلاله.. ذلك القفل الضخم لم يعد موجودا وإن كانت بعض المسامير الصدئة المغروزة في العروق تدل عليه.. ثمة دلائل على وجود الجماد ولا دليل واحد على وجود الأحياء سوي محض ذكريات سجينة ذهن شاحب وجسد كليل.. امتلأ المدخل بالقاذورات والماء الآسن – لم تكن مياه البحر تلك المرة – أصدر الباب صريرا مزعجا عندما حاولت فتحه.. ولاحت رائحة عفن وعطن كريهة.. سقط الطلاء الأخضر والرسوم المنقوشة على الباب.. وبدت عروق الخشب متآكلة مسودة.. وجد النمل والحشرات فيها مسكنا مناسبا وملائما..وإندفعت الأسراب غادية رائحة في خيوط ممدودة.. تسعي وتكد في عالمها.. كانت حياة أخرى تتخلق وتتوالد.. لسنا وحدنا في هذا العالم.. يمكن للحياة أن تمضي دوننا.. هل نبالغ في قيمة الوجود الإنساني؟..
الحوائط حول الباب قد تشققت وبدت فيها الفجوات.. بضعة حوامل خشبية مستندة على الأرض تمنع المبنى من السقوط.. عروق أخرى تمنع السقف من الإنهيار.. الدرج قد سقطت بعض درجاته وبقيت أخرى.. كم من الخطوات قد صعدنا وهبطنا عليه ولم تخلف أثرا؟.. ” الدرابزين” الذي كنا ننزلق عليه قابضين عليه بأيدينا بعيدا عن أعين الكبار أختفي خشبه العتيق وبقيت بعض قضبان الحديد الصدئ الملتوية .. ترى ما حال ” السطح” و الزروع الزاهية وعشة ” الفراخ” و ” غية” الحمام.. مازال الحمام يطير في السماء.. لكنه لا يهبط عليه.. عله وجد مسكنا جديدا.. هل مازال العم يعود كل صباح من جولات العوم؟.. من يفض غموض لغز ” المفتش عاطف” “لريم” الآن؟..هل مازالت تعقد جدائلها؟.